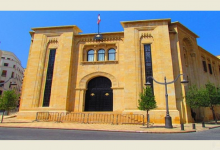حل ازمة النازحين: ليس بالخبز وحده!

وصلت أزمة اللاجئين السوريين في لبنان الى نقطة حاسمة. وطالما لم يوضع حد لدوّامة العنف في سوريا، من المرجح أن تزداد الأزمة الانسانية سوءاً، ويبقى اللاجئون في لبنان وقتاً طويلاً دون ان يتمكنوا من العودة الى بلادهم.
تقول دراسة بحثية غربية ان أحد الخطوط العديدة للحبكة التي ضلّت الطريق في مناقشات الصيف الفائت حول ضربة عسكرية أميركية ضد سوريا، هو وتيرة خروج اللاجئين من البلاد. فأزمة اللاجئين، كما تبدو في حالها الراهنة، كاسحة ومن المرجّح أن تستمر على هذا النحو. ومن شأن تدخّل عسكري خارجي أن يسرّع وتيرة حركة النزوح الجماعي ويفاقم ما هو أصلاً حالة إنسانية طارئة.
تضيف: اتّسعت رقعة أزمة اللاجئين السوريين بسرعة حتى أصبح من المستحيل التخطيط فعلياً لأي تدابير تهدف إلى تحسين الوضع. في أواخر أيلول (سبتمبر) 2012، كان عدد اللاجئين المسجّلين أقل من 240 ألفاً، أما في الوقت الراهن فارتفع هذا الرقم إلى مليوني لاجىء بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. هذا عدا عن ملايين الأشخاص الآخرين النازحين داخلياً، الذين تركوا منازلهم ولا يزالون داخل الحدود السورية. وفي حين يعرب معظم اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم، لا تميل الإحصاءات إلى تأكيد عودتهم. وتُعرِّف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «حالات اللجوء طويلة الأمد» على أنها الحالات التي يعيش فيها اللاجئون في المنفى لخمس سنوات أو أكثر، من دون إمكانية جدّية لإيجاد «حلّ دائم» لهم، أي ترحيلهم أو دمجهم في البلد المضيف أو إعادة توطينهم في بلد ثالث. ووفقاً لهذا التعريف، يُعَدّ ثلثا اللاجئين المسجّلين عالمياً، وعددهم يفوق الـ 7 م لايين، في حال إهمال طويلة الأمد، وسيُضاف إليهم العديد من السوريين على الأرجح.
لايين، في حال إهمال طويلة الأمد، وسيُضاف إليهم العديد من السوريين على الأرجح.
ازمة شاقة
تتابع الدراسة: يجعل عددٌ من العوامل أزمة اللاجئين السوريين المتنامية شاقةً على نحو خاص.
أولاً: يأتي النزوح جزءاً من نزاع مدني شرس لا يبدو أنه ينحسر. وتالياً، تصبح العودة إلى الوطن غير واقعية، تماماً كما الانتظار حتى «نهاية النزاع» لمناقشة مشاكل اللاجئين على المدى الطويل. فحشود اللاجئين والنازحين داخلياً تتطلّب مساعدة إنسانية واسعة النطاق الآن لتلبية الحاجات الأساسية.
ثانياً: ثمة أعداد ضخمة من السكان اللاجئين في خمسة بلدان على الأقل، أي مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة بذل جهد واسع النطاق منسَّق دولياً بغية التوصّل إلى حلول دائمة. فأي من هذه البلدان المضيفة ليس متلهّفاً لمنح السوريين إقامة دائمة، والعديد منها تعهّد تكراراً بألا يفعل ذلك.
ثالثاً: تحدث عملية النزوح بموازاة اضطرابات إقليمية، حيث بعض بلدان المقصد إما يُعَدّ أيضاً من المشاركين الفاعلين في الأزمة السورية، وإما يخوض نزاعاً أهلياً خاصاً به، الأمر الذي يجعل وضع اللاجئين السوريين حرجاً.
رابعاً: لا تنفصل وضعية اللاجئين عن مسائل السياسة، بما في ذلك التطييف المتنامي للنزاع السوري ونظرة المنطقة إلى هذه الحرب. والواقع أن هروب اللاجئين تحديداً هو أحد العوامل الرئيسة المؤدّية إلى توسّع النزاع خارج الحدود. فالنازحون هم مؤشّرات إنسانية على قدرة النزاع السوري على إعادة رسم خريطة المنطقة، وإشعال العداء المذهبي في البلدان المجاورة.
خامساً: يقع اللاجئون السوريون عند نقطة تقاطع أنواع مختلفة من الهجرة القسرية، تشمل الترحيل بسبب الحرب والتوترات الإثنية أو الدينية، إضافة إلى تدهور الحياة الاقتصادية والبيئية. فالسوريون في البلدان المجاورة هم إما لاجئون أو مهاجرون شرعيون أو عمّال زوّار، وإما مهاجرون غير شرعيين. وثمة لاجئون يوجدون في مخيمات رسمية أو غير رسمية، على طول الحدود وفي المناطق المدنية الكبيرة، ولاجئون ينتشرون بين السكان المحليين، وذلك حتى في بلدان مثل تركيا حيث كانت الاستعدادا ت لاستقبالهم أكبر. والحال أنه تصعب حتى مهمة إحصاء أعداد النازحين.
ت لاستقبالهم أكبر. والحال أنه تصعب حتى مهمة إحصاء أعداد النازحين.
الموارد
وتعتبر الدراسة ان هذه العوامل كافة يتردّد صداها في لبنان. فرغم انتشار اللاجئين في خمسة بلدان، تحمّل لبنان العبء الأكبر من النزوح الجماعي باستقباله أكثر من 750 ألف لاجىء مسجّل أو ينتظر التسجيل. وتزعم الحكومة اللبنانية أن عدد السوريين في لبنان بلغ المليون قبل تصاعد حدّة القتال. ويشير تقرير للبنك الدولي، الذي نُشِرَت أهم نتائجه، إلى أن الأثر الاقتصادي للأزمة السورية على لبنان مدمّر، إذ ان الاقتصاد اللبناني يعاني خسائر تراكمية تُقدَّر بـ 7،5 مليارات دولار. كما أن تدفّق السوريين يرفع معدّل البطالة ويدفع الحكومة إلى اقتراض المزيد من الأموال لتلبية الخدمات العامة. كما يرزح اللاجئون تحت وطأة المعاناة والتوترات اليومية. والعديد من المنظمات السورية غير الحكومية الجديدة التي أُنشِئَت لتأمين الخدمات، يديرها لاجئون سوريون من الطبقة الوسطى، ومن الحاصلين على تعليم أفضل نسبياً، منهكون تماماً هم أيضاً. ويعرب معظم اللاجئين عن رغبتهم في العودة أو إعادة التوطين لأنهم ما عادوا يحتملون البقاء في لبنان في ظلّ هذه الظروف الصعبة. فتكاليف الحياة في لبنان تُعَدّ مرتفعةً للغاية مقارنةً بمثيلاتها في سوريا، واللاجئون جميعهم يستنفدون مدّخراتهم. أما الأسوأ حالاً منهم فهي انهم محصورون في مساحات صغيرة غير آمنة وغير صحية، وهم يشكون الاستغلال المتمثّل بالأسعار المرتفعة للإيجار والغذاء والدواء. هذه المظالم هي نفسها المظالم التي يعانيها السوريون في الأردن، كما العراقيون الذين لا يزالون يعانون في مختلف البلدان العربية في ظلّ أمل ضئيل في إيجاد حلٍّ دائمٍ لهم. فضلاً عن ذلك، وصلت مع النازحين حديثاً أعدادٌ كبيرةٌ من الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون المخيمات والبلدات في سوريا منذ العام 1948. هؤلاء يُحظَّر عليهم قانوناً، بصفتهم فلسطينيين، اتخاذ الوظائف الرسمية في أكثر من 70 مهنة. وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يضمّ حوالي 425 ألف لاجىء فلسطيني، ورفضُ توطين هؤلاء هو مطلب لا تنفكّ تكرّره الأحزاب السياسية من اليمين واليسار. وثمة توجّه (أو على الأقل تصوّرٌ) لدى منظمات الإغاثة غير الحكومية بتحويل أموالها من اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في البلاد إلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين الوافدين حديثاً. في هذا الإطار، أجرت المؤسسة الأميركية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) تقويماً لاحتياجات الفلسطينيين السوريين، ووجدت أن 10 بالمئة منهم فقط يعملون في لبنان، وان هذه المعاناة كلّها تزيد من التوترات ضمن الجاليات الفلسطينية الحالية، اذ ان استقبال لاجىء يعني مشاطرة الموارد مع شخص جديد أو أسرة جديدة، الأمر الذي يؤدّي إلى استنزاف موارد المضيف الضرورية. و«في حال الفلسطينيين، أصبحت منظمة الأونروا مرهقةً إذ فتحت مدارسها لاستقبال اللاجئين الجدد. وبما أن هذه الجالية التي تعيش في لبنان هي الأفقر في المنطقة بأسرها، تحتاج هي أيضاً إلى الغذاء أو المال اللذين يجري توزيعهما. وهكذا، على الفلسطينيين أن يتعاملوا مع هذه الصعوبات المحدّدة إضافةً إلى الأزمة المتعدّدة الأبعاد التي يعانيها اللاجئون جميعاً. ومن الشكاوى المتواصلة شكوى تتعلّق بالتعليم. لوضع الصورة في إطار أوضح، يُقدَّر عدد الأطفال السوريين في لبنان اليوم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً، بـ 300 ألف طفل. وفي الوقت نفسه، يبلغ مجموع الأطفال اللبنانيين المسجّلين في المدارس الرسمية في أنحاء لبنان كافة 300 ألف طفل أيضاً. ومع أن الحكومة اللبنانية طلبت من المدارس الرسمية قبول الأطفال السوريين، لا يتلقّى تعليماً فعلياً سوى 30 ألفاً من هؤلاء الأطفال. يُذكَر أن بعض السوريين يعودون إلى ديارهم متَحدِّين الحرب فقط ليتمكّنوا من تسجيل أنفسهم أو أطفالهم في المدارس أو الجامعات.
 تأثيرات
تأثيرات
تشير الدراسة الى ان تأثيرات الأزمة على المستويات كافة، تطاول لا التعليم وحسب. اذ إن البنية التحتية اللبنانية وصلت إلى نقطة حاسمة، فبعض القرى يضمّ سوريين يفوقون اللبنانيين عدداً. وعلى سبيل المثال، المستشفيات في سهل البقاع لم يَعُد فيها أسرّةٌ كافية، وثمة مخاوف من تفشّي الكوليرا في المخيّمات غير الرسمية التي انبثقت في كل مكان، ناهيك عن نقص المياه والنظافة. ويخشى العاملون في مجال الصحة أن تقع كارثة صحية عامة في أي لحظة، ولا سيما في المخيّمات غير الرسمية في البقاع. وتلبي المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة الأخرى عدداً مفرطاً من الحاجات الفورية، الأمر الذي يمنعها من التخطيط على المدى الطويل. فهي منشغلة باتخاذ خطوات بسيطة مثل الاستثمار في برنامج لمدة سنتين لتدريب السوريين على توفير الرعاية الصحية – العقلية الأساسية، وهي وسيلة لتخفيف التكاليف وتوفير مهارات التنمية في الوقت نفسه.
وتلفت الى ان الأزمة في لبنان لا يمكن أن تُحَلّ من خلال المساعدة الإنسانية وحدها. فاللاجئون كثرٌ ويائسون للغاية، ومن المرجّح أن يبقوا في البلاد وقتاً طويلاً. وكما يتراجع الاهتمام بسوريا، كذلك ستنضب بئر التمويل. لذلك ينبغي أن يأتي الحلّ من مزيج من الاستثمار في التنمية على المدى الطويل والاهتمام بالحاجات الإنسانية الفورية. في الواقع، ثمة مؤشرات على أن المنظمات الدولية تقوم بهذا التحوّل، ولا سيما في الأمم المتحدة. فخطة الاستجابة الإقليمية السادسة الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي ستحدّد نطاق الاستجابة خلال السنة 2014، يُرجَّح أن تدعم تحوّلاً نحو التركيز على تنمية المجتمعات المحلية. ويركز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) على مسألة الإيواء، بما في ذلك تحديد الأبنية التي يمكن العيش فيها من جديد كمساكن جماعية كبيرة، والخدمات المُدُنية الأساسية، خصوصاً تلك المتعلقة بالمياه والنظافة. ووضع برنامج الموئل نموذجاً للعمل مع البلديات في مجال البنية التحتية السكنية، بما في ذلك تحسين المياه، وتوليد الطاقة، وشبكات الصرف الصحي، وغيرها… هذه الاستراتجية تفيد كلاً من النازحين والمجتمعات المضيفة الأكثر فقراً، وتكتسب أهمية خاصة لهذه المجتمعات التي تشعر عن حقّ بأنها تحتاج إلى الدعم بقدر ما يحتاج اللاجئون الآتون حديثاً.
توترات
وتلاحظ الدراسة ان معظم المنظمات غير الحكومية، اللبنانية منها والسورية، تتنبّه إلى مسألة التوتّرات المجتمعية، وهي تالياً تعمل على معالجتها. وبصرف النظر عن التأثيرات الجانبية للحرب الراهنة، يبقى إرث «الوجود» العسكري السوري في لبنان، الذي استمر ثلاثة عقود، مريراً بعد ثمانية أعوام على انتهائه. فالعمّال السوريون في لبنان لطالما واجهوا تمييزاً وازدراءً. لذلك، تُعَدّ جهود المنظمات غير الحكومية في مجال التوعية والتعليم حول أوضاع اللاجئين أساسيةً لئلا ينظر السكان المحليون إلى وجود السوريين على أنه بلاء. وتشدّد هذه المجموعات على ضرورة أن يبعث الإعلام بهذه الرسائل إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة على السواء. وفي هذا الإطار يتولّى المجتمع المدني السوري في لبنان زمام الأمور. فالعديد من المنظمات غير الحكومية يعمل على توفير الكتيّبات والمعلومات للاجئين والمضيفين في ما يتعلّق بحقوقهم ومسؤوليّاتهم. وتقوم المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجموعات السورية واللبنانية، بعملٍ بطوليٍّ في ظلّ ظروف متوترة سياسياً وصعبة مالياً. بيد أنها بلغت حدود قدرتها، وكفاحُها يجعل أكثر إلحاحاً ضرورةَ وقف العنف فوراً في سوريا ثم التوصّل مباشرةً إلى اتفاق سياسي يتيح للسوريين واللبنانيين التقاط أنفاسهم. والواقع أن تجنّب ضربة عسكرية أميركية ضدّ سوريا، في الوقت الراهن، كان خطوةً مهمةً نحو التخفيف من حدّة الأزمة. وإعلان الرئيس باراك أوباما عن تخصيص مساعدات للبنان هو أيضاً اعتراف مرحّب به بالمشاكل التي تواجهها البلاد. بيد أن الهبات وحدها لا تكفي، فطالما لم يوضع حدٌّ لدوّامة العنف في سوريا، ستزداد الأزمة الإنسانية سوءاً على الأرجح.
طلال عساف